د.مولاي المصطفى البرجاوي// باحث في علوم التربية/ تخصص ديداكتيك العلوم الاجتماعية
تتميز الكثير من العلوم بتغيُّراتٍ في المفهوم والنظرياتِ والأدوات، بعض هذه التغيُّرات قد تكون محدودةً، وبعضها الآخر قد تشكل قفزاتٍ نوعيَّة واسعة، والجغرافيا من العلوم التي كانت ولا تزالُ في تغيُّر مستمر في مفاهيمها[1] وآليَّاتها ومنهجيتها...، كما أن الجغرافيا لن تحظى بمكانةٍ مهمة بين خريطة المناهج الدراسية ما لم تُقدَّم بصورةٍ معاصرة مفيدة للمتعلمين[2]...
على ضوء ذلك، يهدف تعليم الجغرافيا إلى تيسيرِ تفاعل المتعلِّم مع بيئتِه المحيطة به، وتحقيقِ الموازنة بين حاجات الإنسان والمواردِ المتاحة فيها، وتأهيلِه لتفسير كثيرٍ من المشكلات التي تهدِّد وجودَه في هذه البيئة؛ بإتاحة مزيدٍ من فرص البحث العلمي والتقصِّي حولَ هذه المشكلات أثناء تعلُّم الجغرافيا وتعليمها، واكتشافِ العلاقات المتبادَلة بينهما، واتباع المنهج العلمي في حلِّها[3].
وتؤكِّد الكثيرُ من النظريات التربوية أن المفتاح إلى ذلك يَكْمن في تطوير مهاراتِ التفكير الإبداعي لدى المتعلِّم؛ بتعلم الجغرافيا بطريقةٍ استقصائيَّة، تركِّز على حلِّ المشكلات؛ حيث يكون دور المتعلم فيها مستكشفًا ومتقصِّيًا، وصولاً إلى استيعاب المعرفة الجغرافية، وتوظيفها في فهم هذه المشكلات وإبداع الحلول لها.
ولتحقيق ذلك أخذ الكثيرُ من التربويين يطالبون بتطوير طرائق تدريس الجغرافيا؛ بحيث تصبح قادرةً على تحقيق تلك الأهدافِ المتمثِّلة في تطوير مهارات التفكير الإبداعي؛ مِن خلال تدريب المتعلمين على الاستقصاء والتحرِّي، واستخدام أساليب البحث العلميِّ أثناء تعلُّم الجغرافيا؛ لفهم هذه المشكلات، ومواجهتِها، والتفاعل الإيجابي معها[4].
من هنا لزم وضعُ المتعلِّم أمام وضعيات - مشاكل، فليس من الجائز تقديمُ خلاصات ومعلومات عن قضايا جغرافيَّة للمتعلم، ولكن عليه إيجاد دلالات للمعطَى الجغرافي من خلال تساؤلات وفرضيات؛ وذلك بدعم التعلُّم الذاتيِّ؛ للمساهمة في بناء معرفته الجغرافية، هذا البناء يأتي وفق طرح وضعيات - مشكلة[5].
1- تعريف الوضعية - المشكلة (Situation - Probléme):
تعد الوضعية - المشكلة أداة ديداكتيكية فعَّالة في تجاوُز العوائق من طرف جماعة القسم/ الفصل، إن رصد تمثلات المتعلمين وتحليلها، وتحديد الهوَّة بينها وبين المعرفة العلميَّة السليمة؛ قَصْدَ الكشفِ عن العوائق الحاسمة التي تتضمَّنها - يُعدُّ أحد محطات هذه الإستراتيجية وأكثر مراحلها صعوبة[6].
فالوضعية - المشكلة، لا تَكمن وظيفتُها في وضع المتعلِّمِ أمامَ وضعيَّات يستحيل حلُّها، بل الغرضُ من ذلك شَدُّ انتباه وتركيز المتعلِّم إلى واقِعه المحلِّي والعملي الملموس؛ سعيًا لإعطاء المعنى للتعلمات "وظيفية التعلم"، من خلال تنويع الدعامات الديداكتيكية، تجمع بين التعلُّم الصفِّي والتعلُّم الحقيقي في الحياة، واتِّباع أسلوب عادلٍ من خلال ما يسمَّى بدينامية الجماعات؛ ليتمكن كلُّ متعلِّم من خلال دوره التعلمي من تقديم الحلِّ الذي يراه مناسبًا.
وجاء هذا الطرح البيداغوجي - الديداكتيكي في سياق الاتِّجاه التربوي الجديد، الذي صرف العنايةَ من المدرِّس والمادَّة المعرفية إلى المتعلِّم وجعلَه في قلب العملية التعليميَّة - التعلمية؛ إذ لم يَعد المدرس ناقلاً للمعرفة العالمة (savoir - savante) على حد تعبير عالِم النفس الأمريكي Gagné: "بل تنظيم وضعيات التعليم التي ينبغي أن تأخذ بعينِ الاعتبار الأبعادَ الوجدانية والاجتماعية والبيداغوجية والنفسية والديداكتيكية"[7]. للمتعلم وربطه بواقعه ووضعيته الثقافية والمجالية والاجتماعية المحلية.
2- الوضعية المشكلة في الخطاب الديداكتيكي:
أ- أنواع الوضعيات المشكلة: ميَّز الخبيرُ التربوي البلجيكي بين ثلاثة أنواع[8]:
• الوضعيات الاستكشافية (Situation d’exploration): تهدف إلى إحداث خلخلةٍ في مكتسبات المتعلِّم، وتمهد لإرساء موارد جديدة (معرفية، مهارية، وجدانية) عبر بحثٍ أو استقصاء حول موضوعٍ معيَّن.
• الوضعيات الديداكتيكية (Situation didactique): تستهدف تعلُّمَ موارد جديدة، تكون مرتبطة بهدف أو بهدفين تعلميين.
• الوضعيات الهيكلية (Situation Structuration): تهدف إلى هيكلة وبنينة مجموعة من الموارد المكتسبة وتثبيتها.
ب- مكوناتها: تتكون الوضعية - المشكلة من عنصرين أساسيين، هما:
العنصر الأول: السند أو الحامل: ويتضمن كلَّ العناصر المادية التي تقدَّم للتلميذ، والتي تتمثل في:
• السياق والمعلومات التي سيستثمرها التلميذُ أثناءَ الإنجاز، وقد لا يستغلُّ بعضَها في الحلِّ فتسمى معلومات مشوَّشة، تتمثل أهميتها في تنمية القدرة على الاختيار.
• الوظيفية: وتتمثَّل في تحديد الهدف من حلِّ الوضعية، مما يحفز التلميذَ على الإنجاز.
العنصر الثاني: المهمة:
وتتمثَّل في مجموع التعليمات التي تحدِّد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه، ويُستحسن أن تتضمَّن أسئلةً مفتوحة، تتيحُ للتلميذ فرصةَ إشباع حاجاته الشخصية؛ كالتعبير عن الرأي، واتِّخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات.
ت- مقارنتها بالدرس التقليدي:
على الرغم من الطابع الكلاسيكي المهيمن على الدرس في أغلب الفصول الدراسية ، لتداخل اعتبارات متعددة مرتبطة بكثرة الدروس وطول البرنامج الذي يقيد المدرس، سطر أحد الباحثين مقارنة بين الدرس التقليدي والدرس بالوضعية المشكلة لاستثماره ديداكتيكيا في بعض الحالات لتجاوز روتينية التعلم[9]:
|
الخصائص
|
الدرس التقليدي
|
الدرس بالوضعية المشكلة
|
|
دور المدرس
|
مركز العملية التعلمية
|
تحديد الوضعية والأنشطة التي سينجزها المتعلم لمعالجة المشكلة
|
|
إيقاع وتيرة التعلم
|
واحد وموحد لكل المتعلمين
|
مراعاة الفروقات الفردية بين المتعلمين تبعًا لإيقاعاتهم
|
|
الأنشطة
|
دروس تلقينية ودعامات بيداغوجية توظَّف تبعًا لذوق المدرِّس
|
أنشطة توجيهية مختلفة تُوظَّف وفق نجاعتها
|
|
المشاركة
|
سلبية المتعلم تجاه المدرس
|
المساهمة في البناء وإيجاد حلول معرفية ومنهجية للوضعية
|
3- نموذج من وضعية مشكلة في تدريس مادة الجغرافيا:
تتعدَّد النماذج الديداكتيكية، لكن في هذه الورقة نقترح نموذجًا ينطلق من الوضعية المشكلة، ثم الخطوات المنهجية للتدبير الديداكتيكي داخل الفصل الدراسي:
|
الوضعية المشكلة للانطلاق
|
"إن الحلم في تحقيق عالم متحرر من الاسترقاق والاستعباد، عالم ينبذ الاستغلال من أجل أن يتسلق مكانة سامقة في عالم "العولمة" والمعرفة والتقدم - هو حلم يراود كلَّ إنسان فقير ومهمَّش، كل إنسان لديه همَّة عالية، لكن الملاحظ حسب تعبير الرئيس الجنوب الإفريقي "أمبيكي": "العالم اليوم أصبح جزيرةَ أغنياء تحيط بها بحارٌ من الفقراء"؛ المرجع: مولاي المصطفى البرجاوي: عولمة الفقر والتخلف في العالم الإسلامي، موقع الألوكة.
|
|
الخطوات المنهجية
|
التدبير الديداكتيكي
|
|
الإشكالية
|
كيف يمكن الخروج من بوتقة التخلُّف بأنواعه إلى مصافِّ الدول المتقدمة؟
|
|
تمثلات المتعلمين:
• سؤال مفتوح.
• ترتيب الوثائق.
• نصوص متناقضة مع منهجية القراءة والتحليل
|
تقسيم المتعلمين إلى مجموعتين:
• المجموعة الأولى: كيف وبماذا يمكن التعرُّف على البلدان الغنية (المؤشرات والمعايير)؟
• المجموعة الثانية: كيف وبماذا يمكن التعرُّف على البلدان الفقيرة؟
تحديد مؤشرات التنمية وتصنيفها إلى:
- مؤشرات التنمية البشرية.
- مؤشرات التنمية الاقتصادية.
- مؤشرات التنمية المحلية.
• تطبيق تقنية العصف الذهني لاستعراض أهم الأفكار.
|
|
تركيب جماعي:
كل مجموعة تعرض نتائج عملها.
|
- الدول المتقدمة: مثل الثالوث العالمي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوربي.
- الدول الفقيرة: بعض بلدان إفريقيا، وآسيا.
- العالم الرابع...
|
|
المفهمة والصياغة.
|
- تحديد مفهوم التنمية والنمو.
- تحديد الفرق بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة.
- الأهم: تطبيق هذه المنهجية لوضع تقرير عن التنمية المحلية للمجال الجغرافي للمتعلم.
|
خلاصة القول:
يؤكِّد أغلب الديداكتيكيين على أهمية توظيف الوضعية - المشكلة في التدريس، وَفق المقاربة بالكفايات، لكن على مستوى الممارسة الصفية ( التطبيق الديداكتيكي) ما يزال مجرَّد صَيحة في وادٍ، ونفخَة في رَماد.
هل يعزى ذلك إلى سوء الفهم؟ أم إلى صعوبةِ التطبيق؟ أم إلى المحدوديَّة المنهجية في التحليل الديداكتيكي لهذا المفهوم؟ أم إلى محدودية الدراسات والأبحاث الديداكتيكية الخاصَّة بالحقل الجغرافي في التوظيف التدريسي للوضعية - المشكلة؟ أم إلى تدنِّي مستوى المتعلمين وما يرتبط بالحياة المدرسية؟ أم إلى تكلفتِها المرتبطة بالاكتظاظ والحيِّز البيداغوجي المخصص للوحدات الدراسية...؟
[1] - محمد شوقي بن إبراهيم (2012)، الجغرافية والهوية الوطنية، مجلة الجمعية الجغرافية السعودية، العدد 3، ص 2.
[2] - إمام البرعي (2006)، تعليم الدراسات الاجتماعية وتعلمها بين الواقع والمأمول، دار محسن للطباعة، ص 8.
[3] - حامد طلافحة، قاسم دويكات(2002)، جغرافية الوطن العربي وأساليب تدريسها، دار الأمل للنشر والتوزيع، أربد، الأردن.
[4] - صلاح هيلات، أثر تعلم الجغرافيا بطريقة المشروعات في تنمية التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف الأول الثانوي، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد الثاني 2013، ص 407.
[5] - المصطفى لخصاضي(2012)، تدريس التاريخ والجغرافيا، المرجعية الفكرية والممارسة الديداكتيكية، إفريقيا الشرق-الدار البيضاء المغرب، ص194.
[6] - محمد الفتى، الوضعية - المشكلة منطلقات في البناء، مجلة علوم التربية، العدد 24، مارس 2003، ص .126
[7] - François Raynal, Alain Rieunier : Dictionnaire des concepts , p128
نقلاً عن عبدالله زروال؛ "المدرس وأسئلة المهنة"، مجلة علوم التربية، العدد 61،ص58.
[8] - -Xavier Rogiers, la pédagogie de l’intégration : Des systémes de l’education et de formation au cœur de la société, de Boeck, 1ére édition, 2010
[9] - لخصاضي المصطفى، تدريس التاريخ والجغرافيا، المرجعية الفكرية والممارسة الديداكتيكية، إفريقيا الشرق، 2012، ص196.























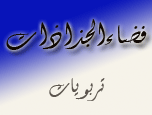
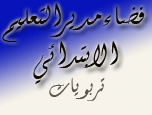

















 ممارس
ممارس






















