لا بد في البداية من الإعتراف بإحساس الوزارة الوصية بالأعباء التي يتحملها مديرو المؤسسات الإبتدائية خاصة بالوسط القروي و المناطق النائية إذ عليه القيام بزيارات تربوية لكل الوحدات الفرعية المكونة للمجموعة المدرسية، إضافة إلى إنجاز كل ما تتطلبه النيابة من إحصاءات متوالية و روتينية سواء للأطر العاملـة أو للمتمدرسيـن و إعطـاء نسب الحضـور و الغياب و نسب النجاح و الإنقطاع و كل مايخطر على البال أو لايخطرناهيك عن التكلف بالإطعام المدرسي و ترأس كل المجالس : التدبير و مجالس الأقسام و مراقبة النقط و ملء الدفاتر المدرسية لكل التلاميذ في فترات وجيزة و تسليم النتائج إضافة إلى نسخ كل المطبوعات التي يملؤها أطر المؤسسة (الحركة – الدخول و الخروج – الترقية ...)...
عليه القيام بزيارات تربوية لكل الوحدات الفرعية المكونة للمجموعة المدرسية، إضافة إلى إنجاز كل ما تتطلبه النيابة من إحصاءات متوالية و روتينية سواء للأطر العاملـة أو للمتمدرسيـن و إعطـاء نسب الحضـور و الغياب و نسب النجاح و الإنقطاع و كل مايخطر على البال أو لايخطرناهيك عن التكلف بالإطعام المدرسي و ترأس كل المجالس : التدبير و مجالس الأقسام و مراقبة النقط و ملء الدفاتر المدرسية لكل التلاميذ في فترات وجيزة و تسليم النتائج إضافة إلى نسخ كل المطبوعات التي يملؤها أطر المؤسسة (الحركة – الدخول و الخروج – الترقية ...)...
كل هذه المهام تنتظر المدير في غيـاب لأي إطـار مساعد خلافـا لسلكـي الإعـدادي و الثانوي.
مهام كثيرة تزداد حدتها عند بداية السنة و نهايتها و كذا عند امتحانات التلاميذ خاصة المستوى السادس.
فكان من المفروض إذن أن يكون للمدير مساعد ، إلا أن المذكرة المنظمة أغفلت جوانب كثيرة و اشترطت شروطا غير كافية فوقعت بذلك في تناقضات جمة، سأبين ما استطعت التوصل إليه انطلاقا من الواقع الذي نعيشه خلافا لمن أصدروا المذكرة و هم طبعا يسمعون بالعالـم القـروي و لا يعيشونه إلا على الخرائط، و كما يقال " ليس من رأى كمن سمع ".
أولا : تجب الإشارة إلى أن هذه المسؤولية هي إضافية للأستاذ الذي سيتحملها بعد أداء واجبه في القسم.
ثانيا : أن المذكرة36 الصادرة بتاريخ13مارس2008 لاختيار مساعد المدير لم تحدد المهام، بل تم تحديدها فيما بعد في المذكرة رقم 132 بتاريخ 26/11/2008.
ثالثا : و هذه هي النقطة السلبية جدا هو أن بعض المجموعات المدرسية يعمل بها 12 أستاذا بها مساعدين للمدير الذي يعمل مثلا بالمركزية بـ 4 أساتذة و وحدتين بـ 4 في كل وحدة. و غالبا ما توجد هذه المؤسسات بالوسط شبه حضري حيث عدد التلاميذ كبير في كل وحدة بينما مجموعات أخرى في مناطق جد نائية بها أكثر من 18 أستاذا ليس فيها و لو مساعد واحد لكون كل الوحدات لا تتعدى ثلاث أساتذة رغم أن هذه المؤسسات في الواقع هي التي تحتاج إلى مساعدين للمدير.
رابعا : أن هناك مجموعة من الوحدات يتجاوز عدد الأساتذة الثلاثة فامتنعوا عن تحمل هذه المسؤولية لأسباب جد منطقية كانت فيما قبل غياب واضح للمهام و حساسية نقطة تتبع مواظبة الأطر العاملة بفرع الوحدة المدرسية + التكوين في المجال الإداري بينما هم بحاجة أولى إلى التكوين في المجال البيداغوجي إضافة إلى المزج بين مهمتين شاقتين (القسم و الإدارة).
خامسا : و هذه النقطة ربما لم تكن في حسبان منظري المذكرة، هو كون البنيات التربوية في العالم القروي تخضع دائما لتغييرات سلبية كالضم و التفييض، فكم من أستاذ ترشح لهذه المسؤولية و ملء المطبوع و صودق عليه ليجد نفسه هذه السنة و قد فقد شرط عدد الأطر العاملة بالوحدة، و قس على ذلك الإستفادة من الحركة أو تغيير الوحدة المدرسية مما سيجعل من الصعب الحفاظ على نفس المساعدين، و ستهدر الجهود المبدولة في التكوينات.
و قد يتساءل البعض عن الحل، بالنسبة لي قد أدلي ببعض الإقتراحات منها :
أولا :خلق إطار خاص بالمديرين.
ثانيا أن يحدد المساعد انطلاقا من العدد الإجمالي للأساتذة العاملين بالمؤسسة و كذا عدد التلاميذ و أن يكون للمدير مساعد واحد متفرغ لهذه المهمة.
ثالثا: أن تتم متابعة الذين تحملوا هذه المسؤولية بتكوينات مستمرة متكاملة عوض العشوائية المتوقعة بسبب تغيير المساعدين في كل سنة.
رابعا: أن يسود التعاون بين كل الأطر العاملة نظرا لجسامة المسؤولية.
خامسا : ألا تصدر مثل هذه المذكرات إلا باستشارة المعنيين بالأمر و عدم الإقتصار على التخمينات التي أثبتت فشلها للوهلة الأولى.
سادسا : أن الوضع الحالي للقطاع لا يتحمل مزيدا من التجارب.
و عموما أي تجربة تصطدم في البداية بعراقيل و عقبات نتمنى الإستفادة منها و تجاوزها عما قريب و الإهتمام الشمولي بالتدريس في العالم القروي.























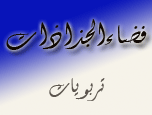
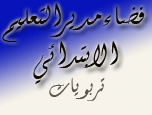










 عليه القيام بزيارات تربوية لكل الوحدات الفرعية المكونة للمجموعة المدرسية، إضافة إلى إنجاز كل ما تتطلبه النيابة من إحصاءات متوالية و روتينية سواء للأطر العاملـة أو للمتمدرسيـن و إعطـاء نسب الحضـور و الغياب و نسب النجاح و الإنقطاع و كل مايخطر على البال أو لايخطرناهيك عن التكلف بالإطعام المدرسي و ترأس كل المجالس : التدبير و مجالس الأقسام و مراقبة النقط و ملء الدفاتر المدرسية لكل التلاميذ في فترات وجيزة و تسليم النتائج إضافة إلى نسخ كل المطبوعات التي يملؤها أطر المؤسسة (الحركة – الدخول و الخروج – الترقية ...)...
عليه القيام بزيارات تربوية لكل الوحدات الفرعية المكونة للمجموعة المدرسية، إضافة إلى إنجاز كل ما تتطلبه النيابة من إحصاءات متوالية و روتينية سواء للأطر العاملـة أو للمتمدرسيـن و إعطـاء نسب الحضـور و الغياب و نسب النجاح و الإنقطاع و كل مايخطر على البال أو لايخطرناهيك عن التكلف بالإطعام المدرسي و ترأس كل المجالس : التدبير و مجالس الأقسام و مراقبة النقط و ملء الدفاتر المدرسية لكل التلاميذ في فترات وجيزة و تسليم النتائج إضافة إلى نسخ كل المطبوعات التي يملؤها أطر المؤسسة (الحركة – الدخول و الخروج – الترقية ...)...






 ابو لمياء
ابو لمياء






















