بقلم محسن زردان
عندما يطلب من التلميذ الإدلاء بشهادة تثبت مقر سكناه ،أو توفره على الجنسية المغربية لقبول تسجيله بمؤسسة تعليمية، هو أمر عادي، لكن أن يطلب منه الخضوع لاختبار مسبق قبل الموافقة على ولوجه لتلك المؤسسة هو بمثابة أمر يثير الاستغراب والاستفزاز، إنها ظاهرة بدأت تستشري في الحقل التعليمي بالمغرب، خصوصا عندما نتحدث عن المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، وغدت تمثل القاعدة وليس الاستثناء، فالظاهر أن الآباء يوافقون في آخر المطاف على إخضاع أبنائهم للاختبارات المسبقة بدعوى الوقوف على قدراتهم ومستواهم التحصيلي، وهي حيلة لا يراد منها معالجة وتدارك النقص الحاصل في تعثرات المتعلمين، بقدر فرزهم حسب المتفوقين منهم والمتعثرين، ليتم بعد ذلك الاكتفاء بقبول المتفوقين في حين الباقية المتبقية يتم إقصاؤها، وللإشارة فقط فعملية الانتقاء تكون هي الأخرى مؤدى عنها، وتزيد إثقال كاهل الآباء، إضافة إلى رسوم التسجيل والواجب الشهري الذي بلغت أرقامه نسبا غير معقولة، في سباق محموم بين تلك المؤسسات التجارية للانقضاض على سوق يلقى رواجا منقطع النظير.
على ضوء ذلك نتساءل، هل هذه العملية يراد منها تحسين وتلميع صورة المؤسسات التعليمية الخاصة، حتى تعطي لنفسها سمعة التفوق وضمان النجاح الباهر بأعلى المعدلات الممكنة وبنسب نجاح تصل إلى 100% كما يحلو للكثير منها تثبيت تلك العبارة على يافطات مداخلها ، حتى تمارس سطوة فرض أثمنة جد مرتفعة على زبنائها، بحجة أنها مصنع لإنتاج التفوق واحتضان النخبة من المتعلمين.
يمكن أن يجد الكثيرون تبرير ذلك في أحقية هذه المؤسسات في السير وفق خيار المنافسة و تقديم منتوج معين يحمل طابع خصوصية المؤسسة التعليمية والشروط التي تتبناها لقبول المتعلمين، علما أن هؤلاء الزبناء هم الذين اختاروا طواعية المجيء لدق أبواب مؤسساتهم والاستفادة من خدماتهم ولم يجبرهم أحد على ذلك، غير أن ما قيل، لا ينفي التصريح أن تبني هذه الظاهرة، هو في الأصل هروب من المسؤولية التي تحتمها أهداف التعليم الكبرى الساعية إلى ضمان عرض تربوي جيد وفق مبدأ المساواة بين كل المواطنين، وبالتالي فإقصاء شريحة مهمة من المتعلمين المتعثرين الذين هم في أمس الحاجة للدعم لتجاوز تعثراتهم و التركيز على المتفوقين منهم، والتغني بنتائجهم هو في حقيقته فشل ذريع لهذه المقاربة لأن نجاحهم هو تحصيل حاصل وسرقة لمجهوداتهم، وضرب لمبدأ الشعارات التي تتغنى بها تلك المؤسسات من قبيل المواطنة والمساهمة في تحسين جودة التعليم.
نتائج الأبحاث الأخيرة التي سلطت الضوء على سر نجاحات الأنظمة التعليمية المتقدمة في العالم، من قبيل فلندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، تفيد أن التركيز أكثر على المتعلمين المتعثرين من أهم مفاتيح تطور مؤشرات التعليم.
يبدو أن تجميع المتفوقين في تلك المؤسسات، يجعلنا نتساءل عن الإضافة التي تقدمها هذه المؤسسات لأولئك المتعلمين مادام الأمر يهدف إلى تدريس المتعلمين المتفوقين، وهو في حد ذاته دليل إدانة على أن الهدف هو بذل مجهود أقل مع الحصول على مقابل مادي أكبر، فأهل الميدان يدركون أن المتعلمين المتعثرين هم أكثر الناس حاجة لبذل مجهود أكبر من أجلهم، وهو ما تتهرب منه هذه المؤسسات، بذريعة أن آباء وأمهات وأولياء المتعلمين المتعثرين يلحون على ضرورة حصول أبنائهم على معدلات عالية ما داموا يدفعون أموالهم، الشيء الذي يحرج تلك المؤسسات وتتفادى بذلك الإعلان عن فشلها أمامهم.
ولو كانت النية حسنة ونابعة من مبدأ التضامن لخدمة الغايات النبيلة للتربية والتعليم، لبادرت هذه المؤسسات إلى تخصيص أقسام وفصول خاصة بالمتعثرين لمساعدتهم على تجاوز تعثراتهم.
صحيح أن هذه الظاهرة يمكن تلمس أعراضها حتى عند بعض المؤسسات العمومية التي كانت تخصص أقسام تحوي المتعلمين المتفوقين، أبناء الأعيان والأسر الميسورة ورجال الأسرة التعليمية، ظنا منهم أن ذلك سيرفع من مستوى أبنائهم التحصيلي، وهم بذلك يضربون بعرض الحائط مبدأ المساواة ويكرسون الإقصاء وسياسة إعادة إنتاج النخب، غير أن ذلك انتبهت له السلطات الوصية بشكل متأخر من خلال برنامج مسار الذي أصبح يتحكم في الخريطة المدرسية بشكل يفرز توزيعا متوازنا للمتعلمين داخل الفصول.
يبقى أن نتطرق إلى مشروعية عملية انتقاء المواطنين من طرف مؤسسات وأجهزة خاصة تمارس مهامها في إطار ترخيص من الدولة وفق مبادئ احترام قوانين الدولة التي ينظمها دستور المملكة الذي يفيد حسب مقتضيات الفصل 31 على أن الدولة تضمن حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة للحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وعلى هذا الأساس فإن عملية انتقاء المواطنين على أساس معايير الاختبارات والروائز التي نجهل طبيعتها ومصداقيتها لا تيسر ولوج المتعلمين على قدم المساواة للمؤسسات التعليمية وبالتالي فهي عملية غير دستورية.























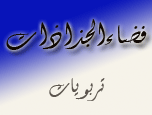
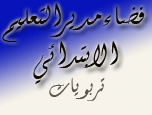

















 محمد
محمد






















